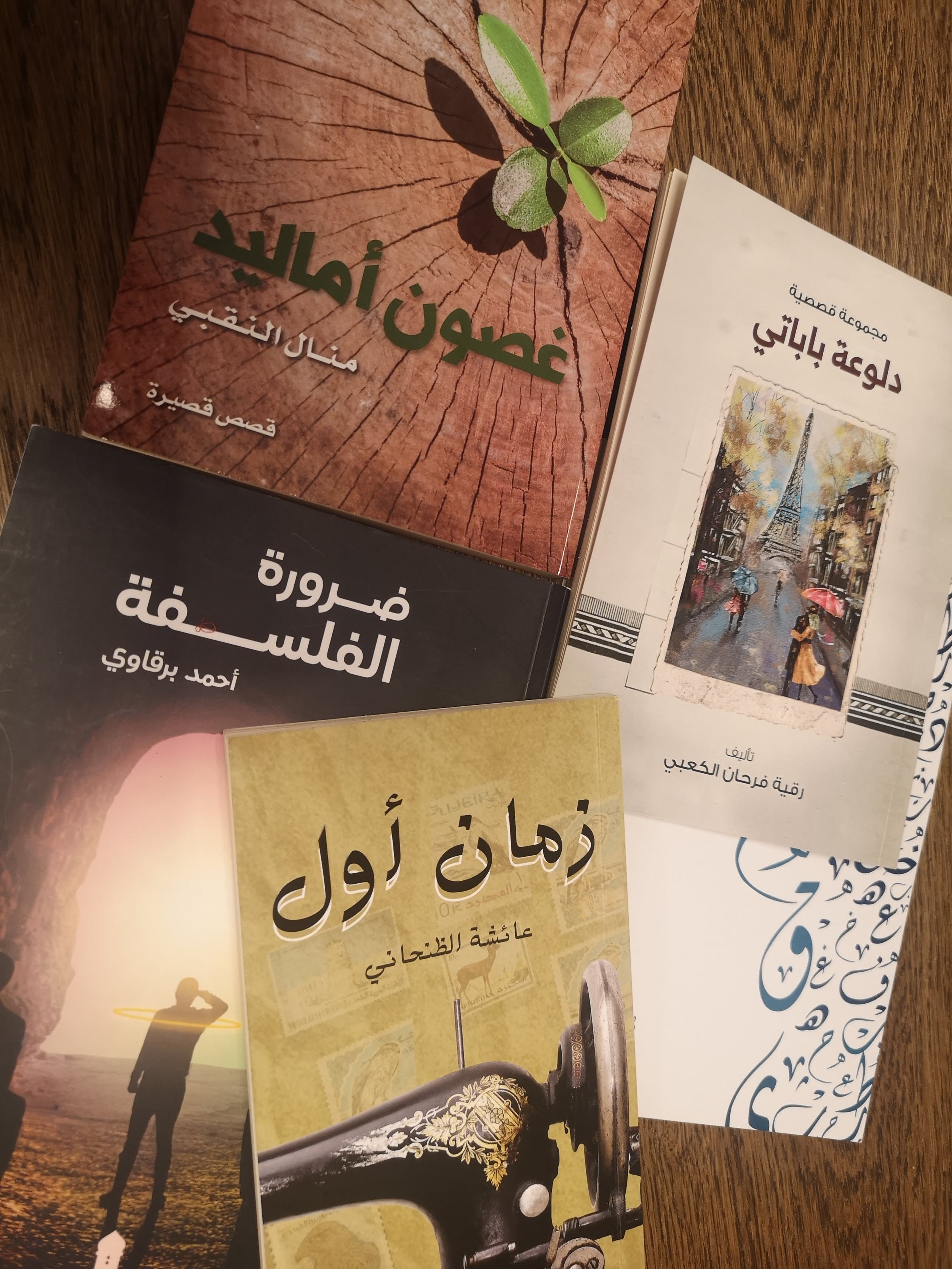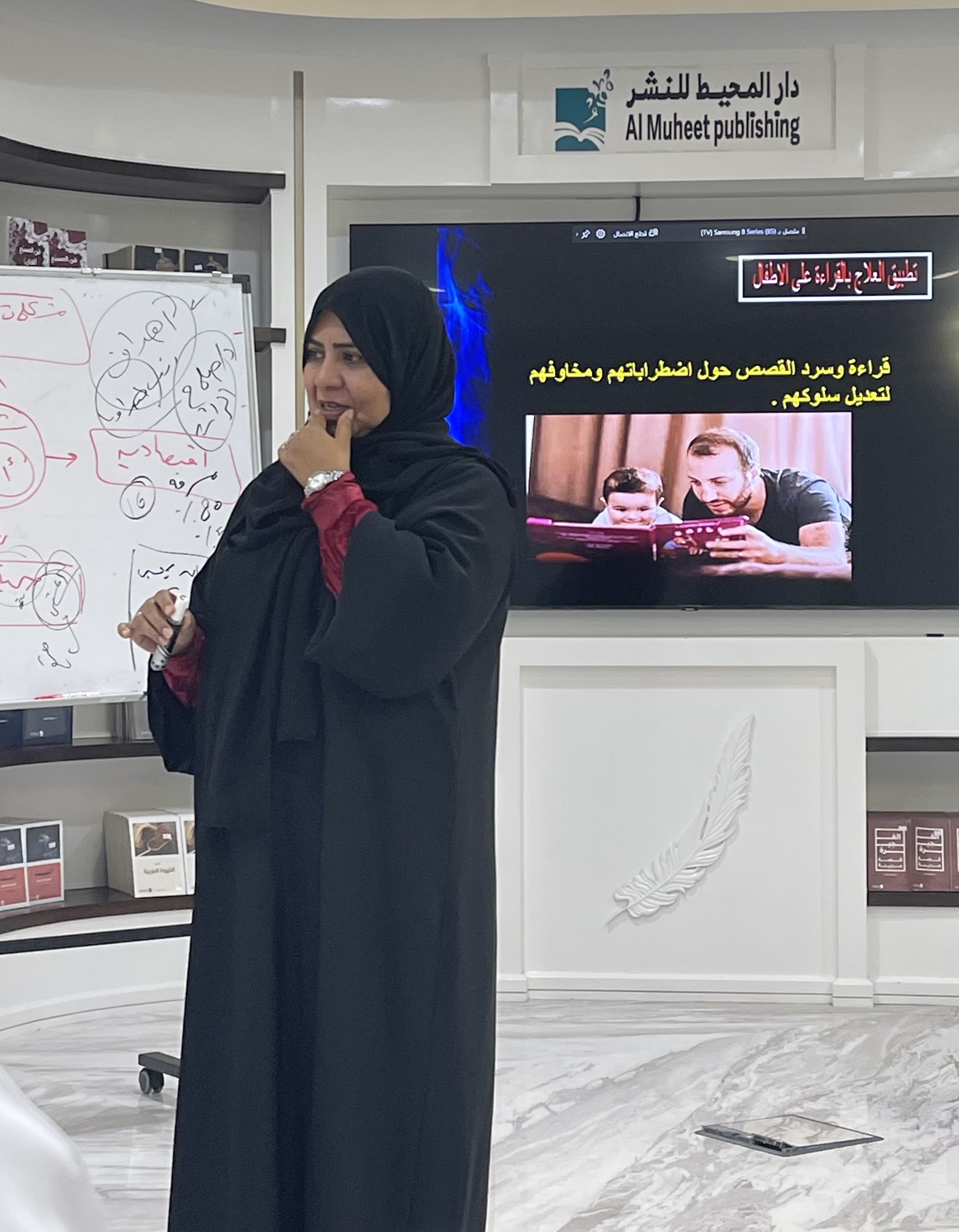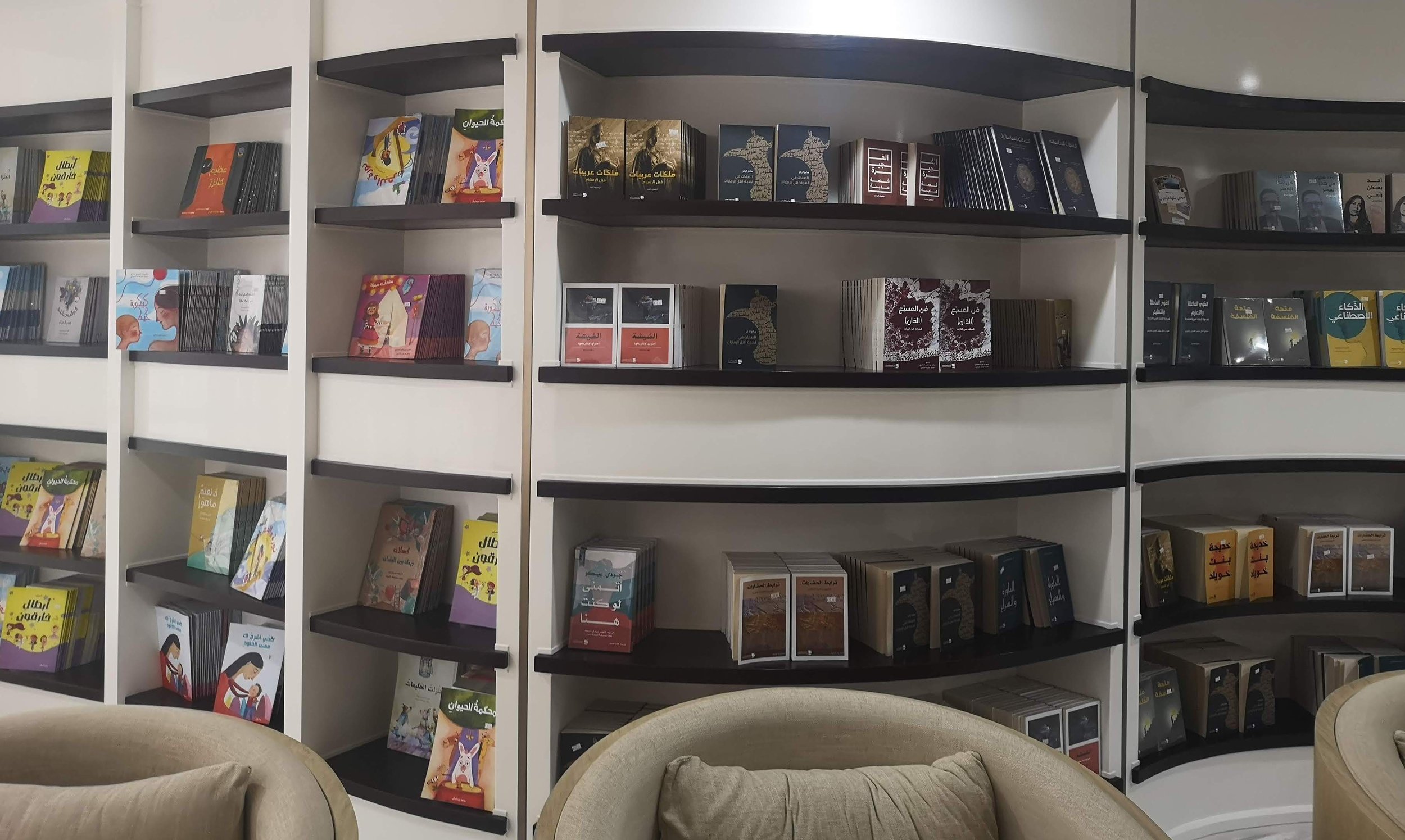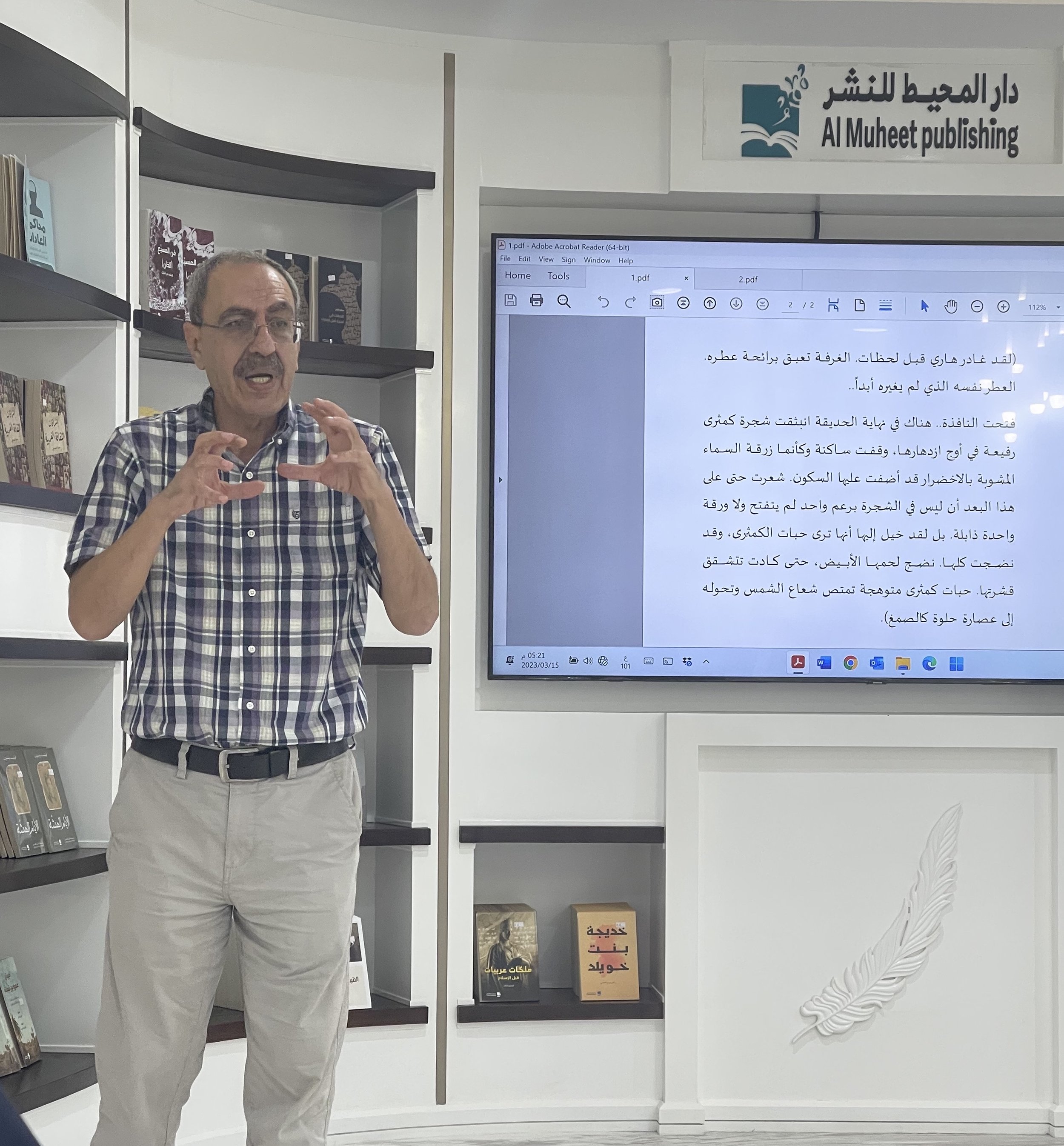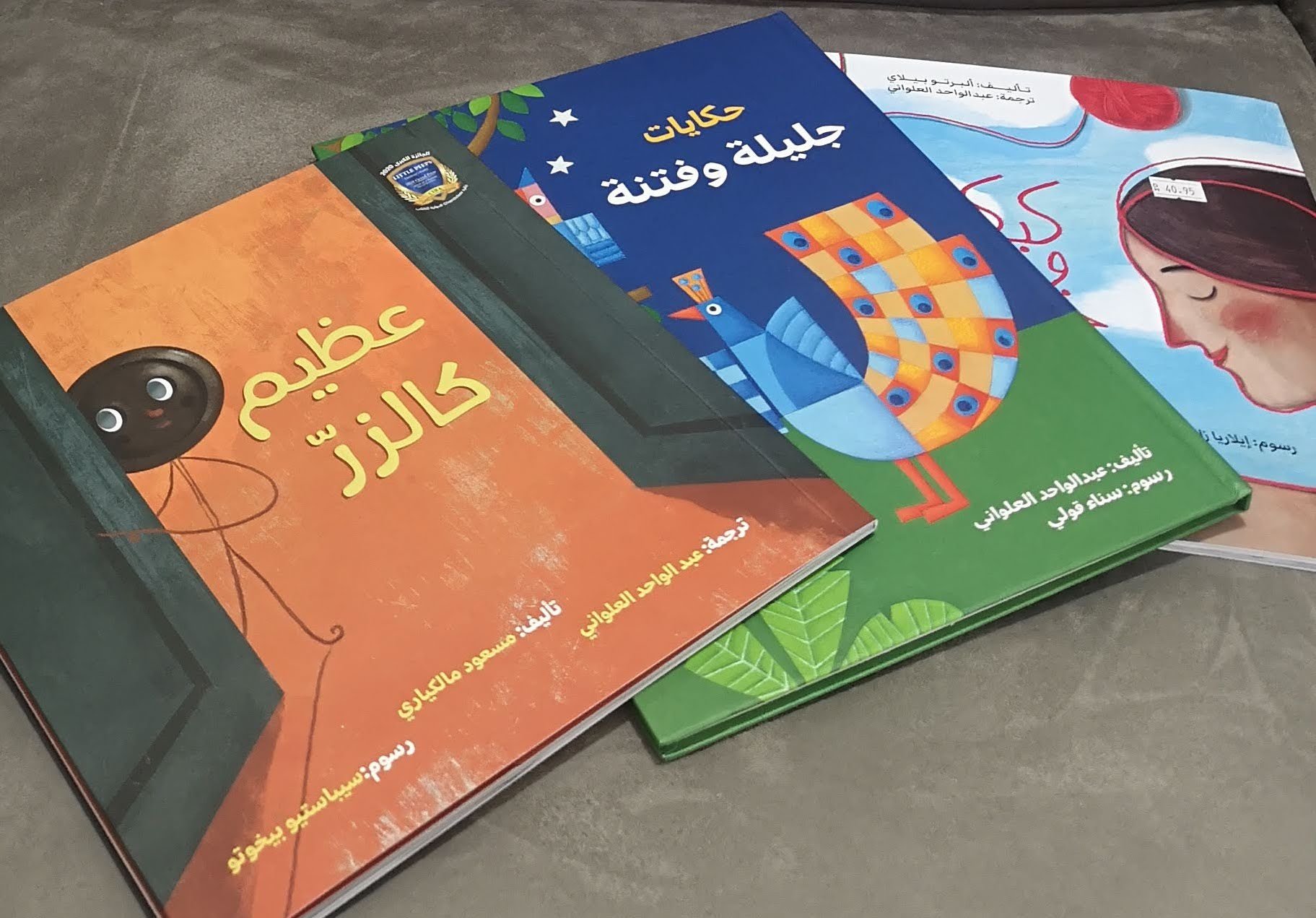تجلّيات الصَّمْتُ في رِوَايَةِ "الصَّمْتِ" لِلْحَمِيدِي (٢٠١٤م)
يحيا النص أكثر من مرة؛ المرة الأولى عندما يخرجه المؤلف من العدم إلى الوجود، والمرة الثانية عندما يرى النور في القراءات المتتالية من قبل القراء والنقاد، حيث يكتسب النص حينئذٍ حيوات أخرى، فيصبح تداوليًا وتشاركيًا في فضاء ينكشف فيه النص بعدد القراء وتأويلاتهم المتعددة له. لذلك، هناك مدرسة أدبية نقدية تنزع إلى القول بـ “موت المؤلف”، وهي النظرية التي طرحها الناقد الفرنسي رولان بارت، ومفادها أن النص، بمجرد خروجه من بين يدي كاتبه، يحيا منفصلًا عنه، إذ يُسلَّط الضوء على النص ذاته وتأويل القارئ له. وهذا ينطبق على كافة النصوص، كما ينطبق على رواية “الصمت” للكاتب محمد الحميدي.
الصمت والثقافة
يبدو أن الثقافة العربية وبعض الثقافات الشرقية تولي الصمت تقديرًا خاصًا، حيث تعتبره من الفضائل ومظهرًا للرشد والحكمة. لدينا المثل المشهور الذي تعلمناه في المدارس: "إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب." وهو تعبير يعكس قيمة الصمت كوسيلة لضبط النفس والتأمل. وقد يكون منشأ هذا الأعراف والعادات الاجتماعية التي تجعل الاحترام للوالدين أو للكبار يكون عن طريق الصمت، والحكيم قليل الكلام أو قد يكون منشأه التدين، وفي الحديث الشريف: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت." لكن الصمت لم يكن مجرد فضيلة في بعض السياقات؛ بل أصبح ظاهرة مجتمعية، خصوصًا بين الفئات المهمشة، مثل الفقراء والمحرومين. في هذه الحالة، لا يكون الصمت خيارًا، بل قيدًا لهذه المجتمعات الصامتة، أي تلك التي لا صوت لها ولا تأثير.
تجليّات الصمت في الرواية
تبدأ الرواية من الحاضر، ثم تتوغل في الماضي، حيث نتابع ولادة الجنين العجيب الذي لم يصرخ عند ولادته مثل باقي الأطفال، لينشأ لاحقًا في أحضان الفقر والجهل والصمت. ثم تعود القصة إلى الحاضر، حيث تتوالى الأحداث التي تحمل طابعًا عجائبيًا، وبعضها يصعب تصديقه لأنها تخرج عن المألوف. الطفل يفهم لغة الأتراك رغم أنه لم يتعلمها، ورئيسة حركة التحرير امرأة يأتمر الرجال بأمرها، وهو أمر غير شائع في السياقات التاريخية التقليدية. ووجود محمية تركية داخل البيئة العربية، لكن تأثيرها على حياة الناس لم يتضح إلا عندما ذهب الفتى ليعطيهم الفاكهة من البستان، وهو ما أدى إلى القبض عليه والضغط عليه للإدلاء بأسرار الحاكم. كما أن الحاكم التركي يتبنى طفلًا عربيًا بملامح واضحة، ويأخذه معه إلى إسطنبول ليقنع الجميع بأنه ابنه، رغم أنه لا يشبهه، والخادمة الشقراء تحكي له قصة بالتركية ويفهمها دون أن يكون قد تعلمها.
كل هذه العناصر مجتمعة تعطي الرواية طابعًا عجائبيًا يقترب من أجواء ألف ليلة وليلة أو عالم خيالي فانتازي، وهذه التفاصيل تجعل الرواية مزيجًا من الواقع والخيال، مما يثير التساؤل حول مدى واقعية الأحداث، وهل يقصد الكاتب تقديم حبكة رمزية، أم أنها محاولة لخلق أجواء سحرية داخل السرد.
يظهر الصمت في الرواية بعدة تجلّيات، إذ تطغى مفردة "الصمت" على النص بدءًا من العنوان الرئيسي وعناوين الفصول الستة: ولادة الصمت، احتفالية الصمت، شهوة الصمت، انكسار الصمت، وصمت الصمت، وخاتمة الصمت. كما تتكرر هذه المفردة في كافة مواضع ومفاصل القصة، حيث وردت حوالي ثلاثمئة مرة، مما يعزّز حضورها القوي في الرواية، والذي قد يسبب من جانب آخر الملل في نفس القارئ. يتجلّى الصمت كثيمة أساسية تدور حولها الرواية، كما يصبح الصمت صفة طاغية في شخصية البطل، الذي اختار ألّا يتكلم ولا يعبر عن نفسه إلا بالإشارات للتواصل مع الآخرين، حتى ظنه الناس أخرسًا. ولا يقتصر الصمت على كونه موضوعًا أو صفة، بل يتحول إلى شخصية حية تتجسد في الرواية، حتى يكاد يكون بطلًا موازيًا للبطل الأساسي، حيث يبالغ الراوي، وهو سارد مشارك، في مدح مزايا الصمت، ما يدفع القارئ إلى التعاطف والتماهي مع هذه الفكرة.
البطلُ الصامت
يبرز الصمت كأداة سردية تُظهر صفة رئيسية، بل طاغية، في شخصية البطل، ليكون دلالة - ربما - على ضعفه وعجزه، كونه طفلًا قادمًا من طبقة معدمة لا صوت لها، أو انعزاله عن الناس الذين لا يشبههم. فهو طفل لا يستمع له أحد، حتى أمه، ولا يشعر بوجوده أحد، فلا رفاق له. تحدث الراوي عن عالم النساء واستثنى عالم الرجال إلا فيما بعد، كما استثنى عالم الأطفال أو وجودهم في صغره. لم يُذكر الأطفال إلا عندما انتقل إلى إسطنبول، حيث لعب معهم في حياته الجديدة، وهذا يثير التساؤل والاستفهام: هل فقد براءته في هذا العالم في خضم الفقر والجهل؟ وكان الصمت إحدى المؤهلات التي ربما رشحته لأن يفكر الحاكم العثماني في تبنيه، لأنه لن يفضحه إن تكلم. وبين العديد من المفارقات، يُعامل الطفل مثل الحمار الذي لا ينطق، في بيئة تستغل طفولته وتُمعن في إذلاله من قبل العديد، ومنهم عبّو وغيره.
تجسّد الصمت: الصمت كـبطل موازٍ"
مع تصاعد أحداث الرواية وتطورها الدرامي، يتضخم الصمت تدريجيًا حتى يُجسَّد وكأنه ظِّل للبطل أو شخصية موازية له، بل يصبح رفيقًا حميمًا، بل حبيبًا، يتعلّق به، يهيم به، يعشقه، ويتنشى بلقائه. يقول البطل: "نحن الاثنان؛ نشكل ثنائيًا متجانسًا." "هل أخي التوأم (الصمت) يمكن أن يسبب لي المشاكل؟" "عشقي للصمت عشق من طرف واحد، الصمت كائن لا يحب ولا يكره."
تحوّل العلاقة بين البطل والصمت
لكن مع تقدُّمِ القصةِ، يحدثُ تحوُّلٌ في علاقةِ البطلِ بالصمتِ، إسماعيلُ يبتعدُ عن حبيبِهِ الصمتِ بمجردِ ارتباطِهِ بحبيبةٍ حقيقيةٍ في أرضِ الواقعِ، سولا، فيضعفُ ارتباطُهُ به، وينطقُ معها فيقولُ "وحدَها أرغمتني على التلفظِ ببضعِ كلماتٍ. حينها، يشعرُ بأنَّ الصمتَ قد صارَ عدوَّهُ اللدودَ، الصمتُ اللعينُ يتفقُ معكَ، وحينَ تذيعُ السرَّ يبدأُ في معاقبتِكَ، لأتفهِ الأسبابِ يعاقبُكَ، إنَّهُ عنيفٌ ولا يَرْأَفُ، دبَّرَ الصمتُ كلَّ شيءٍ.
الصمتُ لم يكن مريحًا ولا صديقًا دائمًا، فقد انكشفَ وجهُهُ الخبيثُ له بعدَ اتصالِهِ بسولا، فيقولُ جميعُ مشكلاتِي تبدأُ بالصمتِ وتنتهي كذلكَ بالصمتِ، الخوفُ يعترينِي عندما يمسكنِي كأنَّنا ما كُنَّا صديقينَ يومًا ما، الصمتُ عميقٌ وغامضٌ. إذن، الصمتُ في هذه الروايةِ ليس مجردَ غيابٍ للكلامِ، بل كيانٌ معنويٌّ متغلغلٌ في وعيِ البطلِ، وهو أكثرُ من مجردِ حالةٍ نفسيةٍ، بل أصبحَ حضورًا طاغيًا في حياتِهِ، لا يفارقُهُ إلا حينَ يجدُ الحبَّ الحقيقيَّ.
وفي الفصلِ ما قبل الأخيرِ، يرضى عنهُ الصمتُ، فيقولُ: "الصمتُ راضٍ عني"، ثمَّ يستعيدُ حضورَهُ الحميمَ فيقولُ: "بعدَ كونِنا عدوينِ لدودينَ صِرْنا أخوينِ، لا يمكنني سوى الاعترافِ بالصمتِ صديقًا مفضَّلًا، إنَّهُ أكثرُ من صديقٍ، أخٌ في هذا الكونِ المليءِ بالضجيجِ"، لكنَّ الصمتَ لا يستمرُّ في الرضا، بل يعودُ للمعاقبةِ، فيقولُ: "الصمتُ غاضبٌ"، ثمَّ يسببُ العاصفةَ وهطولَ المطرِ.
الصفاتُ التي يَنْعَتُ بها البطلُ "الصمتَ" متعددة ومتغيرة حسب تطور القصة: الصمتُ عميقٌ، ذكيٌّ، خبيثٌ، قويٌّ وخارقٌ، يصلُ إلى كلِّ ما يريدُ، يُملي عليهِ أفكارَهُ وأفعالَهُ، فهو ليس مجردَ أداةٍ، بل مهيمنٌ ومسيطرٌ، طاغيةٌ وجدَ فريسةً وانقضَّ عليها. وفي آخرِ الحكايةِ، وحينَ غرقتِ السفينةُ وغرقَ البطلُ، يدورُ حوارٌ بينهُ وبينَ الصمتِ، ونسمعُ الصمتَ ينطقُ للمرةِ الأولى متحدِّيًا ومصرًّا على إنهاءِ حياةِ إسماعيلَ، الذي يتمرَّدُ على الصمتِ ثانيةً، كما تمرَّدَ عليهِ عندما كانَ متعلقًا بسولا، وفي لحظاتِ الغرقِ، حيثُ كانَ متعلقًا بالحياةِ ممثَّلةً في سولا.
قناع الصمت
عند القراءة المتأنية للرواية ندرك أن الصمتَ ليس الثيمةَ الأساسيةَ، رغم أنه يبدو كذلك للوهلةِ الأولى، بل إن الكذبَ هو الثيمةُ المحوريةُ، حيث يتمحورُ الخداعُ حول البطلِ الصامتِ، الذي يخدعُ الناسَ وربما نفسَهُ أيضًا تحت ستارِ الصمتِ. فلقد كذب على كل من حوله، والحاكمُ التركيُّ وزوجتُهُ كذبا على الناسِ بتبنيهما إسماعيلَ، ولم يكن هناك شخصٌ حقيقيٌّ وصادقٌ في الروايةِ كلها. الصحفيُّ يكذبُ في بدايةِ الروايةِ، والخادمةُ تكذبُ أيضًا حين تخيفُهُ بقصةٍ وتتوددُ إليهِ، كما تكذبُ على مخدوميها. أما الناسُ الذين يبحثون عن الامتيازاتِ في أرضٍ لا تخصهم، فهم محتلون وكاذبون.
ويتجلى التناقضُ في النصِّ عندما ندركُ أن البطلَ لم يكن صامتًا بالفعلِ، فهو يتحدثُ مع ذاتِهِ باللغةِ التي تعلَّمها، ويتواصلُ مع الآخرينَ بالإشاراتِ، كما كسرَ صمتَهُ مع سولا. مما يعني أن التزامَهُ بالصمتِ كان مجردَ قناعٍ، وليس حقيقةً، إذ لم يكن معزولًا بالكاملِ، بل متواصلًا، وكأنه اختارَ شكلًا مختلفًا من التواصلِ لا يكونُ لغويًا، بل جسديًا. في علمِ الاتصالِ، يُقال إن المحتوى الجسديَّ للرسائلِ يفوقُ المحتوى اللغويَّ النصيَّ في تأثيرِهِ، وهذا ما فعله البطلُ. لكن الروايةَ لم تلقِ الضوءَ على ما إذا كان البطلُ يعاني اضطرابًا نفسيًا كما أشارَ الطبيبُ، ولا متى أو كيفَ أصابَهُ ذلكَ، إذ لم ترد أيُّ إشارةٍ توضحُ هذا الأمرَ.
وفي الختام، تتكئ الرواية على الصمت في تجلياته المتعددة، وتطرح توترًا بين الشخصية الرئيسية، إسماعيل، والشخصية الموازية، وهي الصمت، الذي تحوّل من رفيق إلى عدو. وكان الصمت قناعًا يستتر به عن واقعه المرير، حتى لحظة موته، حيث اتحد بالصمت إلى الأبد
نجاة ناجي الشافعي
١٧مارس ٢٠٢٥م